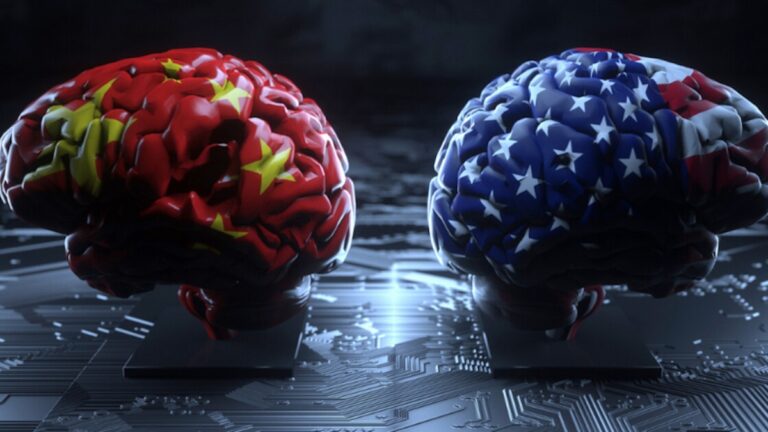إن مركز ثقل العلم يتحرك، ولكن القصة الحقيقية ليست من “يفوز”. بل يتعلق الأمر بكيفية تجديد شبكة الأبحاث العالمية وما يعنيه ذلك بالنسبة للابتكار والأمن والرفاهية العامة في جميع أنحاء آسيا وخارجها.
يسلط تحليل حديث نشرته مجلة نيتشر الضوء على عنوان رئيسي مألوف: إن الإنتاج العلمي في الصين ونفوذها آخذان في الارتفاع مع تراجع الحصة النسبية للولايات المتحدة. ولكن الدرس الأعمق لا يتعلق بالسباق الخاسر بقدر ما يتعلق بالاتصالية: فالعلم عالي التأثير يأتي على نحو متزايد من التعاون الكثيف عبر الحدود، والبلدان التي تزدهر هي تلك التي تظل بمثابة نقاط لا غنى عنها في تلك الشبكة.
ما وراء لوحة النتائج
لعقود من الزمن، كان من المفترض أن تتدفق القيادة العلمية بشكل طبيعي من أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية. وقد ساهم هذا الافتراض في تشكيل كل شيء، بدءًا من المكان الذي يطمح الباحثون الموهوبون إلى تدريبهم فيه، إلى كيفية تعريف المجلات والجهات المانحة والحكومات للمؤسسات “العالمية المستوى”.
واليوم، تحكي البيانات قصة أكثر تعقيدًا، وأكثر إثارة للاهتمام. ولم يعد التفوق العلمي يتركز في ممر جغرافي واحد. تستضيف مناطق متعددة الآن جامعات عالمية المستوى، ومختبرات كبرى، ومجموعات عميقة من المواهب، وممولي أبحاث متطورين. أصبحت الخريطة العالمية لإنتاج المعرفة متعددة الأقطاب.
إن التعامل مع هذا التحول باعتباره منافسة ثنائية بين الولايات المتحدة والصين يتجاهل الأمر الأكثر أهمية. السمة المميزة للعلم الحديث ليست مكان كتابة الأوراق البحثية، بل كيفية تواصل الأفكار والأساليب ومجموعات البيانات والأشخاص والمؤسسات.
يمكن لدولة ما أن تزيد من حجم النشر وتظل أقل مركزية بالنسبة لدوائر البحث الأكثر إنتاجية في العالم؛ ويمكن لأخرى أن تنشر أقل ولكنها تظل جسرًا رئيسيًا عبر الحقول والحدود. موضع الشبكة – وليس فقط الأعداد الأولية – هو الذي يشكل التأثير.
فرضية الجرح الذاتي
أحد أسباب تآكل النفوذ الأميركي ليس الافتقار إلى المواهب أو الاستثمار، بل الخلافات. إن عقبات الهجرة، وعدم اليقين بالنسبة للطلاب الأجانب، والشكوك المتزايدة في التبادل الأكاديمي، يمكن أن تثبط التدفقات ذاتها التي جعلت النظام البيئي البحثي في الولايات المتحدة قويًا للغاية. عندما يواجه الأشخاص الموهوبون والمشاريع التعاونية تكاليف معاملات أعلى، يتم إعادة توجيه الشبكة.
وهذه قصة تحذيرية للجميع، بما في ذلك آسيا. وفي عالم حيث تنشأ الاكتشافات الأعلى قيمة على نحو متزايد من فرق كبيرة متعددة التخصصات ــ موزعة غالبا عبر البلدان ــ فإن السياسات التي تتعامل مع التعاون باعتباره تهديدا من الممكن أن تصبح هزيمة ذاتية. إن المخاوف المتعلقة بالأمن القومي حقيقية، ولكن القيود الشاملة والشكوك المسيسة من الممكن أن تؤدي إلى إضعاف القدرة على الابتكار ذاتها التي تسعى الحكومات إلى حمايتها.
والدرس الذي تتعلمه آسيا واضح ومباشر: فالقدرة التنافسية لا تتطلب العزلة. فهو يتطلب انفتاحًا ذكيًا – قواعد واضحة للتكنولوجيات الحساسة، وأنظمة قوية لنزاهة البحث، وإجراءات وقائية مستهدفة – مقترنًا بمسارات ترحيبية للمواهب والتعاون الموثوق.
الفرصة في التعددية القطبية
إليكم وجهة النظر غير التقليدية: إن العالم الذي يضم العديد من المراكز العلمية القوية هو أمر مفيد للجميع. الاحتكارات تولد الرضا عن النفس. تعمل مراكز التميز المتعددة على خلق منافسة صحية وتنوع الأساليب وتقليل حالات الفشل الفردية في حل المشكلات العالمية.
بالنسبة للاقتصادات الناشئة والمتوسطة الدخل في جميع أنحاء آسيا، فإن العلم المتعدد الأقطاب يخلق خيارات. فالبلدان التي كان عليها ذات يوم أن تنحاز إلى راعي مهيمن واحد يمكنها الآن أن تنشئ محافظ استثمارية: مختبرات مشتركة مع شركاء متعددين، وخطوط تدريب متعددة البلدان، واتحادات راسخة إقليميا تتصل بالخارج بدلا من الاعتماد على الداخل.
وهذا مهم بشكل خاص في فترة التقلبات الجيوسياسية. إن الشراكات المتنوعة تجعل النظم العلمية الوطنية أكثر مرونة. إذا تم تشديد أحد الممرات – من خلال حواجز التأشيرات، أو العقوبات، أو ضوابط التصدير، أو الصدمات السياسية – فيمكن أن تستمر الأبحاث من خلال طرق أخرى موثوقة.
ما الذي ينبغي لآسيا أن تفعله بعد ذلك؟
ولتحويل التعددية القطبية إلى ميزة دائمة، تستطيع الحكومات والجامعات والممولون الآسيويون أن يتصرفوا الآن بثلاث طرق عملية.
أولاً، أبقِ ممرات البحث مفتوحة أمام الناس. تبسيط مسارات الحصول على التأشيرات للباحثين وطلاب الدراسات العليا، وتوسيع التعيينات المشتركة وبرامج الباحثين الزائرين، وحماية الحرية الأكاديمية والاستقلال المؤسسي. إن تنقل المواهب ليس مسألة “سهلة”؛ إنه شريان الحياة للعلوم عالية التأثير.
ثانيًا، الاستثمار في البنية التحتية التعاونية الموثوقة. وهذا يعني معايير بيانات قابلة للتشغيل البيني، وأخلاقيات وحوكمة قوية للذكاء الاصطناعي والطب الحيوي، ومنصات آمنة لمشاركة مجموعات البيانات الحساسة وأنظمة صارمة لسلامة الأبحاث. الثقة هي العملة التي تمكن العمل عبر الحدود على نطاق واسع.
ثالثا، بناء التكرار من خلال الشبكات الإقليمية و”الصغرى”. ومن الممكن أن تعمل مراكز التميز على مستوى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، واتحادات المناخ والصحة في منطقة المحيط الهادئ الهندية، وصناديق الإبداع عبر الحدود، على تقليل الاعتماد على أي علاقة ثنائية منفردة. والهدف ليس الانحياز إلى أحد الجانبين، بل ضمان بقاء النظام البيئي العلمي في آسيا متصلا حتى عندما لا تكون السياسة كذلك.
الخطر المشترك
إن الخطر الحقيقي لا يكمن في الانحدار النسبي لأميركا ولا في صعود الصين. إنه يكمن في التجزئة: عالم حيث تنقسم مجتمعات البحث إلى كتل متشددة، وتكرر الجهود، وتخزن البيانات، وتقييد التعاون بشأن المشاكل التي هي بطبيعتها عابرة للحدود الوطنية.
ومن الأمثلة الواضحة على ذلك تغير المناخ، والتأهب لمواجهة الأوبئة، والذكاء الاصطناعي. ولا يمكن معالجة أي منها بفعالية من خلال البرامج الوطنية المنعزلة وحدها. كان “العصر الذهبي” للعلوم يعتمد دائما على مفارقة: التنافس على المكانة والأولوية، مقترنا بالقدر الكافي من الانفتاح للسماح بانتشار المعرفة.
وإذا فقدنا هذا التوزيع، فسوف نستمر في إنتاج الأوراق البحثية – وربما حتى العديد من الأوراق البحثية – لكننا سننتج عددًا أقل من الإنجازات، وعددًا أقل من النتائج التي تم التحقق منها، وعددًا أقل من الحلول التي يمكن توسيع نطاقها. ولن يتم دفع التكلفة في مقاييس الاستشهاد، بل في التقدم الطبي الأبطأ، والاستعداد الأضعف للكوارث، والأنظمة البيئية التكنولوجية الأكثر هشاشة.
إن عالم المعرفة المتعدد الأقطاب لا ينبغي أن يكون عالماً منقسماً بالضرورة. إن التأطير الأكثر إنتاجية ليس الفائزين مقابل الخاسرين، بل العلم المترابط مقابل العلم المجزأ. يمكن لآسيا – موطن العديد من أنظمة البحث الأسرع نموًا في العالم – أن تساعد في تحديد المستقبل الذي سيظهر.
توني يانج هو أستاذ موهوب في جامعة جورج واشنطن في واشنطن العاصمة.